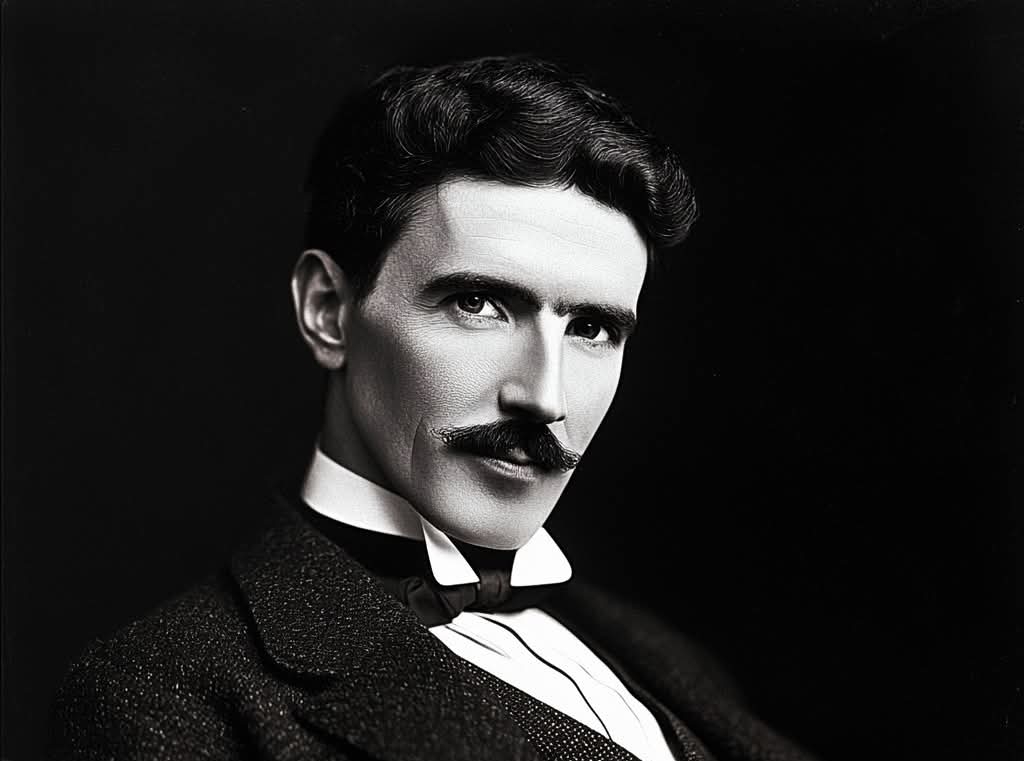لطالما احتلت المدارس الدينية التقليدية مكانة محورية في المجتمعات الإسلامية، بوصفها حاضنة للهوية الدينية واللغوية، وفضاء لتكوين العلماء وترسيخ القيم. وقد شكلت المحظرة الموريتانية نموذجا فريدا في هذا السياق، بما عرفت به من استقلالية وصرامة علمية وبساطة في العيش، وارتباط عضوي بالمجتمع.
غير أن هذه الصورة، رغم قوتها الرمزية، باتت اليوم موضع مساءلة جادة في ظل تحولات عميقة مست البنية الوظيفية والأخلاقية للمحظرة. وتفرض هذه المساءلة نفسها بإلحاحٍ أكبر مع تكرار حوادث وفاة الأطفال داخل بعض المحاضر أو في محيطها، في ظروف لا ترتبط مباشرة بالعملية التعليمية. فهذه الوقائع، مهما اختلفت ملابساتها، لا يمكن اعتبارها أحداثا معزولة، لأنها تمس جوهر العلاقة بين المؤسسة التربوية ومن هم تحت رعايتها. وهنا يبرز السؤال المركزي: هل تقتصر مسؤولية المحضرة على تلقين المتون وحفظ القرآن، أم تمتد لتشمل حماية النفس البشرية وصون كرامة الطفل وضمان سلامته الجسدية والنفسية؟
لا ينفصل هذا السؤال عن السياق الاجتماعي العام الذي تعمل فيه المحظرة اليوم. فالتحولات التي مست بنية الأسرة والمجتمع - من تفكك أسري وفقر وهشاشة قيمية - ألقت بأعباء جديدة على مؤسسات لم تنشأ أساسا لتحمل أدوار مركبة تتجاوز التعليم. وهكذا وجدت بعض المحاضر نفسها، واقعيا وليس قصدا، فضاءات تجمع بين التعليم والرعاية والضبط الاجتماعي، دون أن تتوفر لها الأطر القانونية أو الإمكانيات البشرية الكافية لهذا الدور.
وفي ظل هذا الواقع، سجلت ممارسات لا يمكن قبولها أخلاقيا ولا شرعيا، من إهمال صحي وعنف بدني وظروف معيشية قاسية، تبرر أحيانا باسم "التربية" أو "التقاليد". غير أن مثل هذه التبريرات لا تصمد أمام مبدأ لا تعليم بلا أمان ولا علم يبنى على انتهاك كرامة الطفل أو تعريض حياته للخطر.
ويتعمق الإشكال مع التحول البنيوي الذي عرفته المحظرة في العقود الأخيرة، حين انتقلت في كثير من الحالات من فضاء قائم على التكافل والزهد إلى مؤسسة مأجورة. وليس في الأجر ذاته ما يدان، فالمعلم أحق الناس بأجره، لكن الخطر يكمن حين يفصل الأجر عن المسؤولية، ويغيب التنظيم والمحاسبة، فتترك أمور الرعاية والسلامة للاجتهاد الفردي، وتستغل الرمزية الدينية لإسكات النقد أو تأجيل الإصلاح.
وفي هذا السياق المختل، تحولت بعض المحاظر إلى ما يشبه المكب الاجتماعي غير المعلن لأطفال الأسر العاجزة عن تربية أبنائها، أو الأسر المفككة بفعل الطلاق أو الفقر. ففي حالات كثيرة، لا يكون إرسال الطفل إلى المحضرة خيارا تربويا واعيا، بل مخرجا اضطراريا للتخلص من عبء التربية، ونقلا للمسؤولية من الأسرة إلى مؤسسة تعليمية لا تملك أدوات الرعاية الشاملة.
وهكذا يصل الطفل إلى المحظرة مثقلا بحرمان سابق، ليجد نفسه في فضاء يفتقر، في بعض تجلياته، إلى الحد الأدنى من شروط الحماية النفسية والجسدية. عندها تتحول المحضرة، من حيث لا تشعر، من ملاذ للعلم إلى امتداد لسلسلة الإهمال الاجتماعي، فتصبح ضحية لفشل الأسرة والمجتمع، وتسهم في الوقت نفسه في إعادة إنتاج هذا الفشل.
هذا النقد لا يستهدف المحظرة بوصفها تراثا أو رمزا، ولا ينكر ما قدمته تاريخيا من خدمة للعلم والمعرفة، لكنه يرفض تحويل التاريخ إلى حصانة أخلاقية تمنع المساءلة. فالمؤسسات لا تقاس بماضيها، بل بقدرتها على حماية الإنسان في حاضرها، ولا معنى لأي تعليم - دينيًا كان أو دنيويا - إذا لم يكن آمنا، رحيما، وحافظا لكرامة الطفل.